ضيف العدد ١٤ أ. د. علاء الدين عبد الحميد بهجت

أجرى الحوار وأعده
الاستاذ. محمد محروس عريف
نائب المشرف العام لمنتدى الفيزياء التعليمي
هو عالم مصري وعربي، عشق الفيزياء منذ نعومة أظافره، وعشق معها تراب الوطن، وأنشد معه ألحان الوفاء والعزة والكرامة، نشأ وترعرع في أسرة ثورية، شاركت بقوة في كتابة تاريخ الوطن، وحمل على كتفيه مهمة تربية جيل مصري يعشق الفيزياء، أبهرت أبحاثه العالم، ورسمت خارطة طريق لناسا على المريخ.
إنه أستاذي الذي زرع حب الفيزياء في أوصالي، وكانت دائماً كل حركاته وسكناته مصدر إلهام لي حتى الآن، إنه الأستاذ الدكتور/ علاء الدين عبد الحميد بهجت أستاذ فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الأزهر.
السيد أ. د. علاء الدين عبد الحميد بهجت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلاً بك أستاذنا في مجلتنا. ونود من سيادتكم أن تطلع قارئنا على بعض ملامح حياتك.
1- البطاقة الشخصية والعائلية لسيادتكم.
الاسم/ علاء الدين عبد الحميد محمد بهجت (A.A. Bahgat)، أستاذ دكتور الجوامد التجريبية بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، والمولود بمدينة الإسكندرية في 2 أغسطس 1949، متزوج من سيدة ومربية فاضلة، خريجة كلية الآداب جامعة عين شمس، قامت بتدريس اللغة الإنجليزية لعدة عقود بمدرسة طلائع الكمال الإسلامية بمصر الجديدة بالقاهرة.
وإن كان لي أن أفخر فإن الله رزقني بثلاثة أبناء هم: المهندس وائل، خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي يعمل حاليا رئيس فريق مبرمج للحاسبات، بإحدى الشركات الكبرى للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس عمر خريج كلية هندسة شبرا قسم مدني، ويعمل حاليا كمهندس استشاري بإحدى مكاتب الإنشاء العقاري، والسيدة المعيدة رُبى خريجة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، حيث تعمل معيدة بقسم دعم القرار.
كما أعتز بأحفادي، سيف الدين ونور الدين وزياد ومعاذ وبلال، أدام الله عليهم الصحة والعافية. كما أعتز بأصولي العائلية، حيث إن والدى عبد الحميد محمد بهجت ابن الطبيب محمد بهجت، وكان يشغل منصب وزير تجاري مفوض، ومن قبل ذلك كان ضابطا في الجيش المصري، ومن مجموعة الضباط الأحرار، وأمينا لصندوق هيئة التحرير، وتولى قيادة مجموعة حملة تأميم قناة السويس بمدينة بورسعيد عام 1956، وكان قد التحق بالكلية الحربية عام 1937 بعد تخرجه في كلية التجارة العليا، وحصل على المركز الأول من ضمن الخريجين في تخصص إدارة الأعمال، وقد شارك في الدفاع عن مدينة الإسكندرية طوال فترة الحرب العالمية الثانية، كضابط في سلاح المدفعية المصرية، وتم تكريمه بإرساله في بعثة إلى بريطانيا عام 1945 للحصول على درجة أركان حرب في التخصص الجديد حين ذلك “الرادار”. وقد تزوج عام 1946 من والدتي كريمة الصيدلي. الأستاذ الدكتور/ إبراهيم رجب فهمي (Prof. Dr. I.R. Fahmy) عميد الصيدلة العربية الحديثة.

يهمني في هذا المجال الإشارة إلى أن والدتي رحمها الله، قد لاحظت في طفولتي وصباي رغبتي المتقدة على فك وإعادة تركيب وفحص الأشياء والآلات مثل الساعات والراديوهات…الخ، مما كان يؤدى إلى خسائر جمة في المنزل. فبالإضافة إلى معاملتي بالحسنى _بالرغم من كثرة الخسائر التي تسببت فيها_ عملت على تزويدي بألعاب تنمى قدراتي العملية واليدوية، وكلها تميزت بالفك والتركيب. فقد حباني الله مقدرة يدوية وعقلية تفكيكية تخيلية معقولة، استمرت معي طوال حياتي العملية، مما أضاف لي الكثير من القدرة على بناء وإصلاح الأشياء وحبي للعمل اليدوي.
2- متي التحقت بكلية العلوم؟ وما سر التحاقك بها؟
التحقت بكلية العلوم جامعة الأزهر، بعد حصولي على الثانوية العامة عام 1966 في المدرسة القومية الثانوية بمصر الجديدة. والحقيقة إنني التحقت بكلية الطب جامعة الأزهر، ولم تكن لي الرغبة في هذا الطريق، وذلك لرغبتي المتأصلة في نفسى لدراسة علم الفيزياء منذ أن كنت تلميذا بالمرحلة الثانوية، حيث كنت أقضى أغلب وقت الفراغ في مكتبة المدرسة، وقد وقع في يدى كتاب مترجم “قصة الفيزياء لجورج جاموف” و”المبادئ الأساسية للفيزياء الذرية”، ما زلت أحتفظ بنسخة من كل منهما، وكذلك كتاب في سيرة العلماء، حيث اتضح لي حين ذلك بأن علم الفيزياء هو مصدر كل العلوم، وتقدمه يعنى تقدم باقي العلوم والأنشطة الإنسانية، فقررت حين ذلك بأنه الطريق الذي سوف أتخذه في حياتي. وللأسف فقد عارضني والدي في هذه الرغبة، لمعرفته لأحوال البلاد وعدم تقديرها للعلم والعلماء، ولم يغفر لي بتاتا تركي لكلية الطب على غير رغبته.
3- المؤهلات العلمية، والتدرج الوظيفي.
كما أوضحت، فبعد حصولي على الثانوية العامة والتحاقي بكلية العلوم جامعة الأزهر، حصلت على درجة البكالوريوس في الفيزياء الخاصة عام 1970، ومن ثم التحقت بالدراسات العليا في نفس الجامعة للحصول على درجة الماجستير 1973، ثم الدكتوراه عام 1975 تحت إشراف أ. د. نبيل عيسى و أ. د. عثمان المفتى، في تخصص كان جديدا في تلك الفترة “دراسة الخواص المغناطيسية لمواد خزفية بتطبيق ظاهرة موسباور Mössbauer effect (الامتصاص الرنينى لأشعة جاما)”. وقد تم تحرير ونشر على المستوى الدولي عدد تسعة بحوث مستخرجة من تلك الرسائل العلمية، مازال بعضها يتم الرجوع إليه حتى الأن في العديد من البحوث الدولية من الغير. ومن الذكريات المضحكة والمبكية في نفس الوقت التي أجدها مناسبة للسرد، هو تأكيد قاطع بعدم تقدير بلادنا للعلم والعلماء، فقد تم عقابي بالقانون _وليس بغيره بعدم ترقيتي إلى درجة أستاذ مساعد، وذلك لحصولي على درجة الدكتوراه في خمس سنوات بعد حصولي على البكالوريوس، حيث ينص القانون على أنه لا يمكن ترقيتي إلا بعد ست سنوات من البكالوريوس! وقد كان هذا الحدث أول صدمة لي تعارضت مع ما قرأته في كتاب قصص العلماء، ومازال هذا المبدأ ساريا حتى الأن. وبالرغم من ذلك لم أتعلم الدرس حين سافرت لاحقا عام 1977 إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة لدراسات ما بعد الدكتوراه (Post Doctor)، وعدت إلى أرض الوطن بالرغم للعروض المغرية التي قدمت لى (حيث نشرت عدد ثماني أوراق بحوث علمية جديدة خلال فترة تواجدي)، فقد تعلمت من أبى وأمي أن بلادنا تحتاج إلى أمثالي لكى تتقدم!
المهم، بعد عودتي قمت بالتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مساعد (أستاذ مشارك) عام 1982، وتقدمت بعدد 36 بحثا منشورا على المستوى الدولي، وإن أجيزت ترقيتي، ولكن الصدمة الثانية جاءت في تقرير ترقيتي حيث تنصحني لجنة الترقية بعدم نشر بحوث قصيرة (Short notes)، حيث قمت بنشر خمسة منها منفردا! وذلك بعكس ما تعلمته أثناء فترة عملي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن مثل هذا النمط يدل على أهمية البحث وأن به فكرة أو نتائج علمية جديدة أو تفسير علمي لم يتطرق إليه أحد من قبل، وعلى كل لم ألق بالا بتاتا لهذه النصيحة.
وخلال الأعوام التالية تمت دعوتي إلى إجراء بحوث بجامعة ماربورج بألمانيا الاتحادية بمعهد المعادن، حيث قضيت فترة قصيرة نتج عنها نشر بحثين دوليا لخواص فيزيائية لبعض المعادن المصرية ذات الجدوى الاقتصادية، مستخدما ظاهرة موسباور.
وفى عام 1987، تمت ترقيتي إلى درجة الأستاذية بعد تقدمي بعدد 28 بحثا جديدا. وخلال الأعوام التالية، سافرت إلى المركز الدولي للفيزياء النظرية ICTP بتريستا إيطاليا مرتين، حيث شاركت عام 1988 في فعاليات الدورة الأولى للتوصيل الكهربي الفائق. هذا بالإضافة إلى سفري إلى العديد من دول العالم للمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية (ألمانيا، اليابان، أستراليا، جنوب أفريقيا، إيطاليا، أسبانيا، الأردن)، هذا غير زيارتي لبعض الدول بغرض السياحة والترحال. وقد سافرت إلى دولة اليمن في إعارة إلى جامعة صنعاء خلال الفترة من 1988 إلى 1990. كما سافرت في إعارة إلى المملكة العربية السعودية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها في الفترة من 2004 إلى 2007. وما أن بلغت سن الستين عام 2009 حتى شغلت درجة أستاذا متفرغا حتى الآن.
4-لسيادتكم صورة مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ما السر وراء تلك الصورة؟
 كما أوضحت، فإنني كنت تلميذا بالمدرسة القومية بمصر الجديدة، حيث كنت أزامل صديقي المرحوم د. خالد جمال عبد الناصر، حيث كان يجمع جميع زملائه كل عام للحضور إلى منزله المتواضع _نعم فقد كان بيتا لا يختلف كثيرا عن أي بيت أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وإن كان أوسع قليلا لما تفرضه الظروف_ بمنشية البكري للمشاركة في يوم ميلاده، وطبعا كانت مناسبة لا يمكن رفضها، حيث كنا نتقابل ونحن شباب في مقتبل العمر مع بطلنا الأول الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله.
كما أوضحت، فإنني كنت تلميذا بالمدرسة القومية بمصر الجديدة، حيث كنت أزامل صديقي المرحوم د. خالد جمال عبد الناصر، حيث كان يجمع جميع زملائه كل عام للحضور إلى منزله المتواضع _نعم فقد كان بيتا لا يختلف كثيرا عن أي بيت أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وإن كان أوسع قليلا لما تفرضه الظروف_ بمنشية البكري للمشاركة في يوم ميلاده، وطبعا كانت مناسبة لا يمكن رفضها، حيث كنا نتقابل ونحن شباب في مقتبل العمر مع بطلنا الأول الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله.
5-تولي سيادتكم اهتماما خاصا بطلبة كلية التربية، ما السبب وراء ذلك؟
آمنت ومازلت بأن تقدم الدول يبدأ _بدون منازع_ بالتعليم، والتعليم يبدأ بالمدرس الكفء وهذا لا يتأتى إلا عن طريق واحد، ذو اتجاهين بالتفاعل بين المعلم والطالب والعكس. وعليه فقد أخذت على نفسي أن أكرس جزءا من واجبى التدريسي بالاهتمام بإعطاء محاضرات لطلاب كلية التربية، وقد ظللت أقوم بهذا الواجب لعدة سنوات باستمتاع، وخاصة كلما لمست تجاوبا من الطلاب لما أقوم به. ولكن نظرا لبعض الظروف الإدارية غير المناسبة امتنعت أسفا عن الاستمرار في هذا الواجب، واكتفيت بالقيام بواجب التدريس لطلاب كلية العلوم، حيث الظروف أكثر ملائمة.
6-ماذا عن تجاربكم ورحلاتكم العلمية خارج مصر؟
 في الحقيقة ابتدأت أسفاري منذ صباي، حيث كان يصطحبني الوالد في أسفاره إلى الخارج في مهماته الوظيفية، حيث سافرت بدءا من عام 1960 إلى ألمانيا الاتحادية، والتحقت بالمدرسة الأمريكية حيث مكثت مدة قصيرة حتى قرر الوالد أنه من المناسب لي أن أكمل دراستي في الوطن، وعليه كنت أسافر سنويا إلى ألمانيا لقضاء عطلة الصيف، وقد أكسبتني تلك الفترة من حياتي العديد من الخبرات والعادات الطيبة، مثل تعلم التحدث باللغة الألمانية، واحترام الآخرين، واحترام الوقت، واحترام العمل (حيث قمت خلال إحدى تلك العطلات بالعمل في أحد المصانع المحلية، وتدربت على صناعة العبوات المعدنية بكافة خطواتها، ولم يتجاوز عمرى حين ذلك 14سنة!). ولا أنسى رحلتي مع والدي عام 1964، من ألمانيا إلى إيطاليا عبر النمسا، والسفر إلى مصر بالسفينة الجزائر من ميناء البندقية، والوصول إلى اليونان وزيارة أثينا والأكروبوليس.
في الحقيقة ابتدأت أسفاري منذ صباي، حيث كان يصطحبني الوالد في أسفاره إلى الخارج في مهماته الوظيفية، حيث سافرت بدءا من عام 1960 إلى ألمانيا الاتحادية، والتحقت بالمدرسة الأمريكية حيث مكثت مدة قصيرة حتى قرر الوالد أنه من المناسب لي أن أكمل دراستي في الوطن، وعليه كنت أسافر سنويا إلى ألمانيا لقضاء عطلة الصيف، وقد أكسبتني تلك الفترة من حياتي العديد من الخبرات والعادات الطيبة، مثل تعلم التحدث باللغة الألمانية، واحترام الآخرين، واحترام الوقت، واحترام العمل (حيث قمت خلال إحدى تلك العطلات بالعمل في أحد المصانع المحلية، وتدربت على صناعة العبوات المعدنية بكافة خطواتها، ولم يتجاوز عمرى حين ذلك 14سنة!). ولا أنسى رحلتي مع والدي عام 1964، من ألمانيا إلى إيطاليا عبر النمسا، والسفر إلى مصر بالسفينة الجزائر من ميناء البندقية، والوصول إلى اليونان وزيارة أثينا والأكروبوليس.
هذا وبعد انتقال والدي إلى العمل بموسكو، عاصمة الاتحاد السوفيتي حين ذلك، قمت بالعمل في صيف1970 بمصانع شركة براون بوفيرى BBC، بمدينة مانهيم الألمانية، والمتخصصة في الصناعات الكهربية الضخمة مثل محطات القوى والمولدات الكهربية. وتم تكليفي بالعمل بمعامل اختبار جودة المواد Werkstofftechnik، حيث اكتسبت خبرة عملية حقيقية في التعامل مع الأجهزة المتقدمة، وإن أبديت في بعض الحالات جهلا، ولكنني تغلبت على ذلك الجهل في أسرع وقت.
وقد تعرفت خلال هذه التجربة الثرية على من هو العامل الألماني، ومدى تفانيه في عمله وحبه له. ومن التجارب التي استمتعت بها خلال تلك الفترة، سفري للعودة إلى موسكو بالقطار الذي استغرق حوالي 48 ساعة في رحلته، حيث اجتزت ألمانيا الشرقية عبر برلين بشطريها، ثم اجتزت بولندا عبر وارسو خلال المسافة الطويلة، حتى موسكو خلال الأراضي الروسية المترامية.
ومازلت أتذكر تلك الساعات التي قضيتها على الحدود بين بولندا وروسيا، حيث يتم تغير عجلات القطار لتناسب أبعاد السكة الحديدية الروسية. وكانت زيارتي لموسكو للمرة الثانية حيث استمتعت بزيارة غالبية مواقعها السياحية واستعمال نظام مترو الأنفاق ومحطاته المبهرة. نعم لقد قضيت فترة صبا وشباب غنية ولم أفوت شيئا يمكن تعلمه قصدا أو غفلة.

هذا وبعد الانتهاء من الحصول على درجة الدكتوراه وزواجي عام 1977 وتكريمي من وزارة التعليم العالي المصرية بمنحة لقضاء سنة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية لعمل أبحاث ما بعد درجة الدكتوراه (Post doctor)، فعزمت على السفر إلى جامعة تكساس بأستن حيث معمل متقدم في تخصصي الأصلي “ظاهرة موسباور” وأشراف Prof. R.L. Collins، ولرغبتي في تعلم واستخدام التقنيات غير المتوفرة بجامعة الأزهر او مصر في ذلك الحين مثل التعامل بتقنيات الهليوم السائل ومغناطيسات فائقة التوصيل. وحصلت كذلك على منحة مدعومة من مؤسسة فولبريت الأمريكية للعمل بهذه الجامعة المرموقة حيث وصلت إلى واشنطن يوم 15/6/1977 برفقة زوجتي، وبحمد الله وفقت في العمل بهذا المعمل وتعلمت هذا التقنيات الجديدة بالنسبة لي، بل تمكنت من نشر عدة بحوث، سوف نقوم الإشارة إليها في حينه. وفى خلال هذه الفترة تعرفت على أسلوب الحياة الأمريكية وعلى تخصصات جديدة، فأبديت رغبتى لأحد الأساتذة بجامعة تكساس للتقنية Texas Tech، (Prof. K. DasGupta) بمدينة لببك، أن ألتحق بمعمله المتخصص في أطياف الأشعة السينية وبحوث ليزر الأشعة السينية.

وفور التحاقي للعمل بهذا المعمل في يناير 1978 وحصولي على منحة من مؤسسة ولش Welsh foundation، تفرغت لتعلم التقنيات الجديدة على والقراءة والاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة حتى جاءت لحظات أصبح الأستاذ المشرف على المعمل يكلفني بمراجعة تجارب الأخريين بالنيابة عنه، وكان قبولي لهذا فوريا بالرغم من معرفتي للخطورة الممكنة للتعرض لخطر الأشعة السينية، فكان علىَ دائما مراجعة التحصينات قبل بدء أي عمل! وفى تلك الأثناء تمكنت لأول مرة من نشر بحث في مجال التوصيل الكهربي الفائق، بل وتمكنت بفضل الله من أن أقوم بابتكار مطياف للأشعة السينية جديد، تم نشر تصميمه ونتائجه في الدورية الأولى عالميا في مجال الأجهزة العلمية (Review of Scientific Instruments). هذا بالإضافة إلى استخدام هذا المطياف في عمل إحدى التجارب الأساسية في مجال ليزر الأشعة السينية تم نشر نتائجه. وقد كانت ومازالت نتائج هذا البحث يعاد استخدامها في الكثير من الكتب المرجعية Text Book على سبيل المثال وليس الحصر كتاب “R.C. ELTON “X-RAY LASERS” وغيره. وخلال هذه الحقبة تم تكريمي بمنحة من مؤسسة ولش Welsh foundation ومنحى لقب Fellow of the R.A. Welsh foundation “زميل مؤسسة ولش” وهي مؤسسة علمية شهيرة تقوم بدعم العلوم والعلماء.
وبالرغم من كل هذا، مازالت في أعماق نفسي كلمات أبى وأصدقاءه “البلد دي (يقصد مصر) محتاجة أمثالك”! فقررت العودة للعمل بموقعي الأصلي مع معرفتي بكم المصاعب التي سوف أواجهها، ولا أنسى حين ذلك مبادرة السلام وانسحاب إسرائيل من سيناء، فقلت في نفسي الأن سوف تبدأ النهضة والبلد سوف تحتاج إلى أمثالي! ولكن هيهات، للأسف وبعد أكثر من ثلاثين عاما لم نر شيئا من تلك النهضة، وبعد أن ذهب أغلب العمر قامت ثورة 25 يناير 2011 على أمل إحياء مشروع النهضة مرة أخرى، والله أعلم.
بالرجوع من رحلتي في مهمة علمية بجامعة ماربورج عام 1984حيث قمت ببعض الدراسات كما أشرت على بعض الصخور المصرية، والتي قمت بنشر نتائجها بالمشاركة مع بعض الزملاء الجيولوجيين في المجلة الدولية للتفاعلات فوق الدقيقة Hyperfine Interactions 1 و 2، قررت في نفسى بالتوقف كليا عن إجراء أية بحوث خارج البلاد في معامل مضيفة وأن يكون جهدي لبلدي ولأبناء ببلدي من طلاب وباحثين، وعلى بناء معملي الخاص بالجهود الذاتية والإمكانات المتوفرة، وأن تكون زياراتي لمعامل الخارج للاطلاع والتعرف على كل ما هو جديد فقط. وبهذا بدأت ما عزمت عليه، وذلك بتصميم وبناء عدة تجارب معملية في مجالات بحثية متعددة “علم الزجاجيات التكنولوجية، التوصيل الكهربي الفائق، الخواص الميكانيكية للفلزات، الأغشية الرقيقة، الخواص المغناطيسية والخواص الفروكهربية والخواص الحرارية والضوئية”. وكان نتيجة ذلك نشر عدد حوالي ثمانين بحثا على المستوى الدولي منذ أن اتخذت هذا القرار. وقمت بالإشراف على 13 دكتوراه و25 ماجستير. وخلال رحلتي العلمية تحملت عبء فحص العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصرية وسعودية وهندية، كما أقوم بشكل متواصل بالحكم على أبحاث دولية للعديد من الدوريات العالمية الموثقة، منها على سبيل المثال Physical Review B وJournal of Alloys and Compounds والعديد غيرهما.
7-أبطال نوبل في العلوم، هل هم أبطال بالصدفة؟ أم بالعمل الجاد؟ أم بالذكاء الخارق؟
أولا علىَ القول بأنه في القرن الواحد والعشرين، لا يمكن لأشخاص عظماء أمثال جاليليو أو حتى نيوتن أن ينجزوا شيئا بإمكانياتهم المالية الشخصية البحتة، وبدون أي دعم من مؤسسات كبرى تقوم على دعمهم ماليا ومعنويا. فيمكننا ملاحظة أن غالبية الحاصلين على جوائز نوبل بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في مجال الفيزياء التجريبية كانوا يقومون بالعمل تحت مظلة إما جامعات مرموقة تأخذ دعم من شركات كبرى أو داخل معامل تخص هذه الشركات.
وبما أن هذا السؤال دار في مخيلتي دائما، وخلال رحلاتي إلى الخارج تقابلت مع الكثيرين من الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء، فقد تقابلت بـ محمد عبد السلام، وستيفان وينبرج، ورودلف موسباور وفيتالى جينزبورج وكارل ألكسندر ميلر وأدوين ماكميلن وأحمد زويل، وتحدثت معهم، وتوصلت إلى الآتي:
5% من الحظ، حيث يعمل كل منهم في مجال يوصله إلى طريق نهايته اكتشاف عظيم.
10% بيئة علمية مناسبة تحفزه وتقدر عمله، وهذا يشمل المجتمع الذي يعيش فيه وتوفيره لحياة كريمة للمواطن عامة وللعالم خاصة.
10% تعليم عالي المستوى، بدءا من مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الجامعية.
5% ذكاء ونظرة ثاقبة (أي يرى ما لا يراه الأخرون).
20% أدوات وتمويل وفريق عمل يساعده على الوصول إلى مبتغاه.
50% جهد وعرق وثبات وحنكة سياسية في أحيان كثيرة، وكلها صفات شخصية وجدتها فيهم كلهم وغيرهم من خلال سيرتهم الذاتية.

وبناءا على ذلك يجب توفر كل هذه النقاط المشار إليها، ليصل العالم المجد إلى جائزة نوبل _محور السؤال_، فإن لم يتوفر إحداها قد يصل إلى نتائج جديدة أو يصل إلى تطبيقات مفيدة، ولكن لجائزة نوبل فبالقطع لا. ولنعد إلى أرض الواقع لنرى أي من هذه النسب تتوفر لأي من العلماء في بلادنا. بدءا دعنا نقول إن بعض من تلك النسب قد تزيد أو تقل، ولكن بالقطع فإن بعض من تلك المعطيات لا تتوفر أصلا، فعلى سبيل المثال، التعليم عالي المستوى غائب كليا، البيئة العلمية غائبة كليا، أدوات وفريق عمل وخاصة الفريق الفني التقني غائب كليا. وكما قلنا فإن غياب واحدة فقط من تلك المعطيات كافية لإجهاض أي محاولة لنهضة علمية حقيقية فما بالك بجائزة نوبل في العلوم!
8- سمعنا منذ سنوات عن مشروع علمي مصري تحت مسمى (الطريق إلي نوبل)، ماذا عن هذا المشروع؟ وكيف يمكن تحقيق نهضة علمية مصرية وعربية من خلال هذا المشروع أو غيره؟
يقع في خطأ فادح كل من يعتقد أنه يكفي لإعداد جيل يمكنه الحصول على جائزة نوبل مستقبلا، ما هو سائد في فكر مؤسساتنا العلمية، وهو أن تزويد المعامل بآخر صيحة من الأجهزة الحديثة يكون الطريق الصحيح، فالأمر غير ذلك تماما، فمثل هذا الفكر قد يؤدي إلى إنتاج أبحاث علمية عالية المستوي فقط، ولكنه بالقطع لا يؤدي إلي جائزة نوبل. فإذا درسنا تاريخ الحاصلين على تلك الجائزة في مجال الفيزياء على سبيل المثال منذ نشأتها عام1901، بدءا من رونتجن مكتشف الاشعة السينية، نجد أنه للحصول على تلك الجائزة لزم على هؤلاء العلماء ابتكار وسائل بحثية غير موجودة بالسوق وقت عمل تلك الاكتشافات، ووجود الخبرة التكنولوجية القادرة علي التنفيذ ومن ثم إجراء أي تعديل علي تلك الأفكار والابتكارات وبالقطع إلي مستوي تعليمي عال قبل كل شيء. ولتقريب الفكرة المطروحة، فالعمل الذي يقوم به أحمد زويل فيما يسمي بالتصوير الجزيئي رباعي الأبعاد تطلب منه تطوير عمل الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، ليحتوي على إضافة لشعاع ليزر في مدي الفيمتو ثانية، يتم عن طريقه بالضرورة تعديل تصميم جهاز الميكروسكوب نفسه، فهل يمكن لأي باحث في أي مؤسسة محلية الاقتراب من المحتويات الداخلية للميكروسكوب الموجود لديه؟! فما بالك بفكه وتعديل تصميمه؟ ! ومن هو القادر فنيا أو تكنولوجيا على ذلك؟ وأين الورشة التي يمكنها القيام بتلك المهمة؟ خاصة أن هذا الميكروسكوب مستورد، وليس لنا فيه سوي التشغيل وفي أحيان كثيرة ليس بالكفاءة المرجوة. وخلاصة القول، فإن الحصول علي جائزة نوبل هو منظومة قومية متكاملة وتشتمل علي مستوي تعليم مرتفع، وهي ليست قرارا سياسيا أو تطوير معمل محظوظ وتزويده بأحدث الأجهزة العلمية أو حني الاستمرار في تطويره بالاعتماد علي ما هو متوافر بسوق الاجهزة العلمية، جريدة الأهرام في 14/10/2009 . أما عن جوائز الدولة فلى فيها رأى منشور في جريدة “المصرى اليوم” بتاريخ 24/5/2010. فقد كنت أتساءل، ومازلت فى حيرة، فالدولة تنادى فى كل وسائل الإعلام بأن العلم والبحث العلمى هما المخرج الوحيد لكل الأزمات، وتذكرت كيف أن أحد البرامج الحوارية المحلية يقول بعكس ذلك! وكان الحوار الساخن يدور بين السيد مقدم البرنامج والسيد المسئول السابق لأحد أهم المواقع العلمية بالبلاد، وبعد أن سأله عن إنتاجه العلمي، وهل هو السبب لحجب جائزة الدولة عنه؟ صرح سيادته بأن هذه الجائزة المحلية الرفيعة، وكذلك جائزة النيل للعلوم، ليستا للإنتاج العلمي للمرشح بل هما تقدمان لمجمل أعماله -الإدارية والوظيفية؟! فالإنتاج العلمي له جوائز أقل أهمية، مثل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق نعم لقد صرح بذلك!! وفى استهزاء بالإنتاج العلمي قال سيادته: “إنه جار الآن دراسة إضافة موضوع الإنتاج العلمي من بحوث إلى قانون منح جوائز الدولة التقديرية والنيل “.. نعم هذا ما صرح به سيادته على الملأ وبدون أي خجل!! فإذا كانت هذه هي الحقيقة – البحث العلمي ليس من متطلبات تلك الجوائز – فالآن فقط علمت لماذا تمنح للوزراء والمدراء وليس للعلماء الحقيقيين القابعين في معاملهم والبعيدين عن شغل المناصب الإدارية!! وإن منحت هذه الجوائز في مرات قليلة لعلماء حقيقيين، ولكن يبدو أن ذلك كان مصادفة، أو أن لهم تلاميذ فى مناصب عليا تمكنوا من مؤازرتهم!! ومساوئ مثل هذه النظم هو توقف العالم الشاب عن البحث العلمي بعد الترقي إلى درجة الأستاذية، ليفرغ نفسه لإيجاد أي دور غير العلم، أو لأي موقع إداري، أو حتى حزبي يؤهله للحصول على الشهرة والمنصب ويمكن المال، بل وقد يحصل على تلك الجوائز رفيعة المستوى محلياً بطرق أقل صعوبة، وبدون الحاجة للجهد المضنى للبحث العلمي. وانطلاقاً من تلك الحال المحبطة للعلماء الحقيقيين فإنني أدعو إلى إنشاء جوائز خاصة لرجال ونساء الإدارة بعيداً عن جوائز العلوم، كما أتمنى أن ينصلح الحال بعد استقرار البلاد ونجاح ثورة 25 يناير بإذن الله.
9- أكثر الأبحاث التي قمت بها قيمة والتطبيقات التي جاءت عنها.
بدءاً يجب علينا أولا تعريف ما هي الأبحاث المنشورة على المستوى الدولي حيث يتم ذلك من خلال دوريات تحت إشراف دور للنشر أو جمعيات علمية، حيث تقوم بنشر نتائج الأبحاث من خلال أوراق تضم في متن مجلد ينشر دوريا بانتظام ويوزع على كافة المكتبات الجامعية حيث يتم تداوله وجدولته لسهولة الوصول إليه. وحديثا تتم هذه الجدولة رقميا عن طريق مؤسسات متخصصة مثل المعهد الدولي للعلوم ISI وموقع البحث Google و Google Scholar أو Google Books، وتقوم دور النشر بوضع هذه الأوراق البحثية على مواقعها الإلكترونية ليمكن الوصول اليها إما مجانا أو باشتراك. وخلال العقود الأخيرة تولت مؤسسة ISI نشر دورية متخصصة لبيان ما يعرف بدليل التنويهات الشخصية Personal citation index كما تقوم بعض المواقع المجانية بعمل تقويم للأبحاث الشخصية وتحدد عدد التنويهات لأى بحث وإعطائه درجات تصغر أو تكبر تبعا لحجم التنويهات، وتقوم كذلك بتقويم الباحثين ومنحهم درجات ترمز لها بمؤشر “h Index” ومؤشر “g Index” كما يتم استخدام مؤشر لدرجة فاعلية الدورية “Impact factor” يحدد مستوى الدورية (المجلة) ومدى استقرارها وأهميتها بين مختلف الباحثين. هذا بخلاف موقع Google Books حيث يشير إلى الكتب المرجعية Text Books التي تم فيها الإشارة والتنويه باسم باحث محدد. وبالرجوع إلى هذه المؤشرات الدولية أجد إنني وبحمد الله (وحتى هذا الحوار) قد جمعت عدد يصل إلى 600 تنويه بحثى وعدد يصل إلى 42 كتاب مرجعي و مؤشر h Index = 14 و مؤشرIndex g = 18، وذلك بعد القيام بتنقية البيانات المنشورة من المتشابهات.
وإن أردنا التحدث عن بعض أبحاثي التي أعتقد بأنها ذات قيمة، فيلزم الإفادة أولا بأن منظومة البحث العلمي وخاصة العملية منها لا تأتى بثمارها بدون فريق بحثي متعاون يحترم أعضائه بعضهم بعضا ويضم مختلف الكفاءات. وفى الحقيقة فإنني أعتز بمجموعة من الأبحاث التي قمت عليها منذ أن نشرت بعض بحوثي المستخرجة من رسالة الماجستير في المجلة الألمانية “فيزياء الحالة الصلبة” “Physica Status Solidi” وبحثى المنشور بمجلة الجمعية الأمريكية للخزفيات ” J. Am. Ceramic Soc.” والذي تم اعتباره في كتاب علم المعادن “Rock forming minerals” وهو الأكثر شعبية بين المتخصصين. وكما بينت عالية عن مجموعة الأبحاث التي قمت بعملها أثناء فترة وجودي بالولايات المتحدة الأمريكية فإنني أعتز بالبحث الذي قمت فيه بابتكار مطياف جديد للأشعة السينية وتطبيقه في دراسة إصدار أشعة سينية ليزرية. كما أعتز بعد عودتي إلى أرض الوطن بأنني أشرفت على أول بحث عملي تجريبي في مجال التوصيل الكهربي الفائق للمواد ذات درجات الحرارة المرتفعة وبدء العمل في هذا المجال الهام بجامعة الأزهر. كما يهمني أن أشير إلى خوضي مجال بحوث المواد الفروكهربية وفتح باب هذا المجال البحثي في جامعة الأزهر لأول مرة، مما أدى إلى اكتشاف تلك الخاصية ذات الأهمية التكنولوجية في العديد من المواد الجديدة (1 و 2 و 3) والتي تم الاعتراف بهم كأول ما هو منشور عنها. وأخص بالذكر ذلك البحث 2 الذي تبعته بحوث أخرى هو إنه الأول في إثبات عمليا وجود ظاهرة الفروكهربية في المواد الزجاجية وأن مجموعتنا البحثية هي الرائدة في هذا المجال العلمي الجديد، وقد أشار إلى ذلك علماء بارزون من اليابان وروسيا وإسرائيل والهند والصين. ويهمني في هذا المجال أن أشير إلى أنه تم بواسطة أخريين نشر عدد من براءات الاختراع المسجلة دوليا، وذلك بعد اعتمادهم لما توصلنا إليه من نتائج عملية ووضعنا لتصور نظري بمنشأ هذه الظاهرة في تلك المواد.
وخلال الفترة بدءا من عام 1995 استهوتني فكرة بناء تجارب بحثية قائمة على الأتمتة Automation باستخدام الحاسب الآلي، فقمت بعد دراسة مستفيضة وجهد ببناء عدة أجهزة متكاملة لعمل قياسات فيزيائية دقيقة ساعدت العديد من طلابي في الحصول على درجتهم العلمية وتوفير الكثير من أموال الجامعة ونشر العديد من الأبحاث الجيدة أخذت نتائج بعضها كمراجع معترفا بها دوليا وطبقت في براءات اختراع لأخريين. وقد شملت هذه التجارب 1- التحليل التفاضلي الحرارى DTA. 2- قياس الحرارة النوعية للفلزات وسبائك اللحام للمكونات الإلكترونية. 3- دراسة خواص الزحف Creep للمواد. 4- قياس القدرة الكهروحرارية للفلزات والأغشية الرقيقة Thermoelectric Power. 5- قياسات التيار المتردد وثابت العزل الكهربي والفقد. 6- قياسات التيار المستمر للمواد عالية المقاومة. 7- بناء تجربة القابلية المغناطيسية للمواد فائقة التوصيل بطريقة التيار المتردد AC magnetic Susceptibility. 8- قياس الخواص الكهربية للمواد الفروكهربية بواسطة عروة التخلف الكهربي.
وفى مشروع بحثي جديد بدأت في دراسة الخواص الفيزيائية المختلفة لمواد نانومترية من أكسيد الفانديوم المحضر بطريقة الهلام المتخثر (Sol Gel) وتم نشر ثمان أوراق بحثية في هذا المجال الجديد، وتوصلنا إلى خواص جديدة كاستخدامه كأقطاب كهربية في خلايا الليثيوم، وكمجس للغازات وخاصة الهيدروجين، ونعمل حاليا على دراسة استخدامه كحاو للهيدروجين بغرض استعماله في خلايا الوقود. وخلال عملي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية أشرفت على ثلاثة مشاريع بحثية في هذا المجال نتجت عنها أربعة بحوث نشرت في مجلات ذات شهرة دولية مثل Philosophical Magazine.
10- استفادت وكالة ناسا من أبحاثكم لتطبيقها علي تربة المريخ، حدثنا عن هذه الأبحاث؟
يعود استخدام وكالة ناسا في بعض منشوراتها العلمية لبحوث قمت بعملها (مع إنني لم أعمل أو أتصل بهذه الوكالة) إلى المعنى الأساسي للنشر العلمي على المستوى الدولي. فقد قام علماء من وكالة ناسا NASA بتطبيق ومن ثم الرجوع لبحوث كنت قد نشرتها في مجال أطياف موسباور. حيث في إحدى هذه البحوث كنت قد اقترحت طريقة جديدة حين ذلك لكيفية التعامل وتحليل أطياف موسباور للمواد المعروفة الأن بالمواد النانوميترية حيث أشير إليه في دراسة تربة كوكب المريخ الحمراء والتأكيد على أن السبب يعود إلى أكسيد الحديد “الهيماتيت” المسحوق مما يعطى للمريخ مظهره الأحمر، وذلك في دراسة صاحبت رحلة سفينة الفضاء فايكينج. وفى بحث أخر تم نشره عام 2004 بالاتصال مع رحلتي المركبتان سبيرت وأبرتيونيتى تم الرجوع إلى نتائج من أحد بحوثي المنشورة لمعدن Ca amphibole من التربة المصرية، حيث اقترحت طريقة لتحديد كمية الحديد في ذلك المعدن.
11- كان لسيادتكم دور بارز في عودة طابا إلي أحضان مصر، حدثنا عن هذا الدور.
القصة ببساطة هو أن والدي رحمه الله كما أشرت عالية كان في مهمة دراسية للحصول على رتبة “أركان حرب” وذلك عام 1945 من المملكة المتحدة وحين عودته إلى الوطن أصطحب معه كتاب أطلس لخرائط توضح توزع التجارة العالمية مطبوع عام 1929 بمطبعة جامعة أكسفورد، حيث توضح بما لا يدخله الشك وقوع منطقة طابا داخل الحدود المصرية وحيث أرسلت نسخة منها إلى مجلة “أكتوبر” خلال فترة اندلاع أزمة التحكيم الدولي التي انتهت لصالح مصر بعودة منطقة طابا. وأحب أن أشير هنا إلى قضية وطنية هامة وذلك بعدم وجود مدينة تسمى “إيلات” لتقع فيما بين العقبة وطابا وهذا يثير الدعوة الوطنية لعودة منطقة “أم الرشراش” المحصورة فيما بين المدينتين إلى أحضان الوطن الأصلي مصر فهي أراضي مغتصبة من التربة المصرية.

12- نظرة د علاء الدين بهجت إلي فيزياء المستقبل، وما هو مفتاحها؟
في فترة نهاية القرن التاسع عشر أطلقت دعوات مفادها بأن علم الفيزياء قد أكتمل ولم تعد هناك قضايا علمية فيزيائية شائكة تحتاج إلى مزيد من البحث، سوى موضوعي امتصاص الجسم الأسود والأثير؟! ففي نهاية هذه الحقبة تم تطبيق علم الديناميكا الحرارية في صناعة القطارات واختراع آلة الاحتراق الداخلي وفى مجال الاتصالات تم استخدام شفرة مورس في التواصل عبر العالم واختراع التليفون عام 1876 وفى مجال علم البصريات الذي أعتبر كاملا حين ذلك، فقد تم بناء تلسكوبات وميكروسكوبيات واكتشاف الميكروبات … الخ، فماذا يبقى؟ وفى الحقيقة قد تبدو هذه المقولة ذات تأثير سلبي على مجريات الأحداث فإن هي قيلت في إحدى البلاد المتخلفة لأقفل باب الاجتهاد وقد يعاقب ويستهزأ بكل من حاول الاجتهاد بعد ذلك. ولكن لحسن الحظ يبدوا أنه لم يلتفت إليها على مستوى أوروبا، بل سار البحث العلمي في طريقه وبخطوات أكثر سرعة، حيث في خلال عقد واحد فقط (1895-1905) أكتشف رونتجن الأشعة السينية عام 1895 وأكتشف باكريل الإشعاع النووي 1895 وعين تومسون خصائص الإلكترون عام 1897 وفى عام 1900 توصل ماكس بلانك إلى فكرة الكم و من ثم توصل أينشتين إلى فكرة الفوتون ووضع نظرية النسبية الخاصة عام 1905. وعليه بدأت فيزياء القرن العشرين (الفيزياء الحديثة أو العصرية) التي مازلنا نعيش ضمنها ونجنى ثمارها. فإذا نظرنا حولنا نجد حاليا أن نمو الفيزياء يعتمد اعتمادا قد يكون مطلقا على تقدم التقنية والتكنولوجيا أكثر من هي أفكارا أساسية من خارج نطاق فترة القرن العشرين. فهل حقيقة وصلنا إلى نفس حالة نهاية القرن التاسع عشر، وانتهت أو كاد إسهامات علم الفيزياء القرن الواحد والعشرين؟! بالقطع يتمتع إنسان اليوم بإنجازات لم تتوفر لأي إنسان من عصور سابقة أو حتى بعض العقود السابقة، فكل شيء يتغير ويتطور بسرعة قد تبدوا للبعض أكبر من قدرتهم على الاستيعاب أو الملاحقة فيرفضها بل ويبتعد عنها وفى أحيان كثيرة يخاف منها ويخشاها. بالقطع لن تستمر هذه الحال طويلا وخاصة إن تطورت طرق التعليم ونقل المعلومات والخبرات بطرق أكثر إنسانية، يأخذ فيها قدرات البشر كأحد عواملها.
دعنا نعود إلى سؤالكم عن مستقبل فيزياء القرن الواحد والعشرون. في بعض الأحيان نلاحظ أن الاهتمام العالمي بمجال معين من البحث العلمي يماثل نمط الاهتمام العالمي بخط الموضة في الملابس أو السيارات، ثم يترك لنذهب إلى نمط أخر قد يبدوا للبعض أكثر تحررا أو حده! فحاليا تدور في الساحة العلمية بحوث فيما يسمى “المواد النانومترية” ويعتبر كل من يعمل عليها بأنه الأكثر فهما لواقع الأحوال، وطبعا هذا صحيح في أغلب الحالات لما تقدمه مثل هذه المواد من رفع لمستوى الحياة البشرية ولصالح صحته. ولكن كل هذه الانجازات هي إنجازات تكنولوجية في المقام الأول مازالت تتبع نسق ومبادئ فيزياء القرن العشرين، وإن بدت بسيطة في غالبية التطبيقات فمازالت معقدة وعالية التكلفة في تطبيقات عديدة تحتاج إلى خلفيات وإمكانيات لا تتوفر لكثير من العلماء المجدين في دول العالم النامي، فتقل مشاركتهم بل قد تنعدم في خضم النشاط العالمي في هذا المجال. فإن تكلمت عن الدراسة في كليات العلوم عامة وأقسام الفيزياء خاصة في بلادنا فالاهتمام الأساسي يرتكز على تدريس مبادئ العلوم الأساسية أو ما يمكن تسميته “تاريخ العلوم”، ولا يهتم بالتطبيقات التكنولوجية بل قد يفتقر في كثير من الأحيان لمعلمين ذوي خبرة تكنولوجية يمكنهم نقلها إلى طلابهم. فالسؤال المطروح هل علينا تطوير أقسام كليات العلوم وخاصة الفيزياء بمقررات ومعامل وورش تمكن المعلمين من تطوير العملية التعليمية لطلاب القرن الواحد والعشرون، بتخصص مثل الفيزياء التطبيقية؟ نعم هذا هو السبيل الوحيد لإنجاز ما يجب إنجازه لمصلحة الخريجين والوطن.
تدور دوائر البحث العلمي حاليا في دائرة للأسف ليس لنا فيها سوى الاطلاع على مجريات الأمور (وللأسف فإن العديد من الفيزيائيين في بلادنا لا يعنيهم هذا الأمر في شيء) وأعنى بذلك بحوث الجسيمات الأولية من بوزونات وفرميونات والتجارب التي تبحث عن جسيم “بوزن هيجز” في المسرع “مصادم الهيدرونات الكبير” بسرن CERN، تلك التجربة العملاقة التي كلفت حتى الأن أكثر من عشرة مليارات يورو، وتكلف التجربة الواحدة ما لا يقل عن أربعة عشر ملاين يورو لاستهلاك الكهرباء فقط. فقد تؤدى الاكتشافات المتوقعة خلال هذه التجارب عالية التقنية إلى مبادئ فيزيائية جديدة والى ظواهر لم نكن نعرفها سابقا، فمثل هذه التجارب يمكن اعتبارها المفتاح لفيزياء القرن الواحد والعشرين. وعلى كل فإن هذا المسرع سوف يستخدم أيضا كمصدر للجسيمات لتعديل تركيب بعض المواد لإضافة خواص جديدة تنفع في تطبيقات مستحدثة.
13- وأخيراً نود من سيادتكم توجيه نصائح لطلبة العلم عامة والفيزياء خاصة.
في عالم اليوم حيث تنتقل المعلومات بسرعة لم يعتدها الإنسان على مدى تاريخه المعروف بعد اختراعه للكتابة، فكانت القراءة ممكنة فقط لعدد قليل من الناس المحظوظين بوجودهم بالقرب من أصحاب القلم، فهي موهبة حبا بها الله بعض من خلقه. وكانت حتى تلك القراءة محدودة بعمر الانسان الذي يضعف نظره بعد بلوغه حوالي سن الأربعين فيتوقف عنها مرغما أو عليه أن يستعين بمساعدة. وكان اختراع نظارة القراءة “ذات العدسة المحدبة” أحد إنجازات علم الفيزياء، بأن فتحت الباب لامتداد عمر الإنسان الإنتاجي العلمي والحرفي فزادت مقدرته وفترة تحصيله للمزيد من المعلومات والخبرة. وبالرغم من هذه القدرة العظيمة التي حصل عليها الإنسان لم تجد معه أي نصيحة! وعلينا قراءة التاريخ. وفى عصر الحاسبات وشبكة الانترنت والتلفزيون المتصل بالأقمار الصناعية أبتعد شباب اليوم عن القراءة. ولكن بالنظر الى مصادر المعلومات الحديثة التي يمكن أن تحل مكان القراءة جزئيا بمتابعة البرامج الوثائقية وإن كانت قاصرة وما زالت لا تغنى عن القراءة، ولكنها قد تدفع المشاهد إلى قراءة كتاب في موضوع أو أكثر جذبته إليه المشاهدة، فبدون القراءة لا يحصل الشخص على معلومة ترسخ في عقله لتحليلها أو الاستشهاد بها، فالقراءة تقدح الخيال وتزيد من سعة مداركه.
وأخص طلاب الفيزياء بالعمل على حل المسائل العديدة في كافة المقررات الدراسية ولتكن مرتبطة بعلم الرياضيات، وأن تتصاعد درجة الصعوبة تدريجيا، فالبحث العلمي الجاد هو في حقيقة الأمر حل لأحد المسائل المطروحة. كما أحثهم على الاطلاع على سير العلماء وتاريخ مسار العلوم وارتياد مجالس العلم وتجنب مجالس السوء والتفاهة.



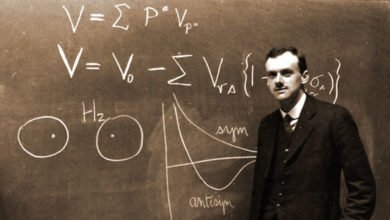


استاذنا و استاذ الاساتذه الدكتور علاء بهجت
قيمه و قامه و علم و خلق لم نرى منه إلا كل خير و تعلمنا على يديه الكثير و الكثير.